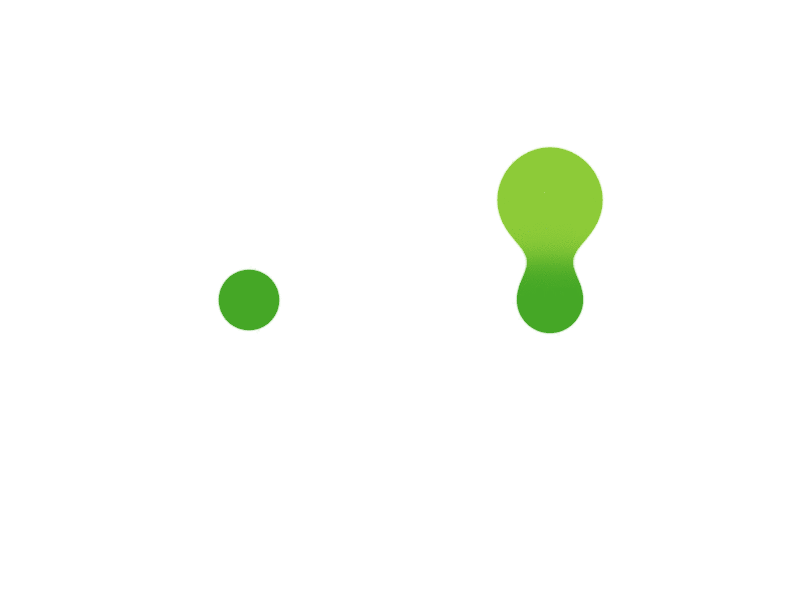
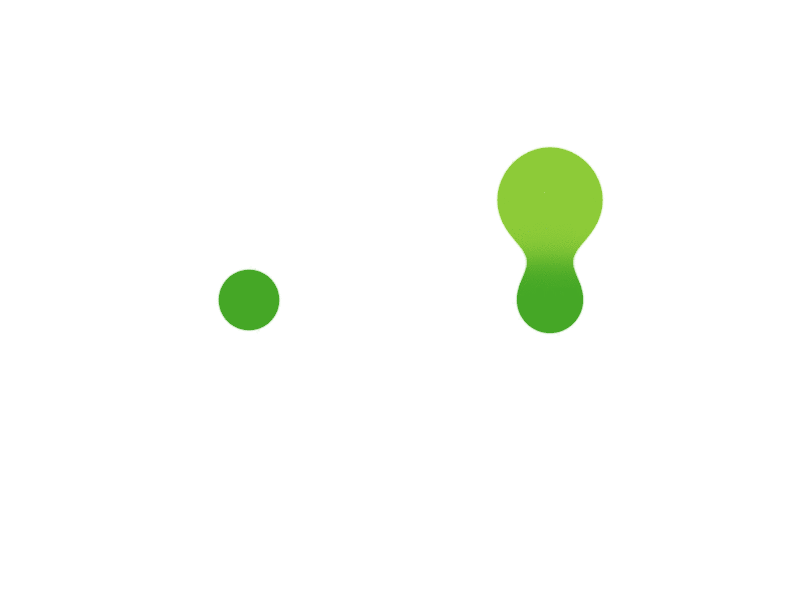
ككل الحواضرالدينية التاريخية، وفي طليعتها مكة المكرمة، استمدت المدينة جانباً كبيراً من شخصيتها من تنوعها السكاني الذي انعكس على نسيجها الاجتماعي وتركيبتها العمرانية، مثلما تمثل في نشاطها العلمي والثقافي. ومع أن هذه جوانب تعد من المتغيرات نتيجة لعوامل الزمن وتعاقب المؤثرات التاريخية، فقد استطاعت مدينة رسول الله أن تحتفظ بالكثير مما يميزها وتلحظه أعين زوارها بشكل خاص ويعيها إدراكهم حين يتأملون تاريخ المدينة ويتعرفون على جوانب الحياة فيها.
لقد اغتنت المدينة كثيراً بمن وفد إليها على مرالعصور من العلماء والزوار سواء للإقامة أو للمتاجرة وتشكلت حياتها الاجتماعية والاقتصادية، مثل حياتها الثقافية العلمية، بهذه المتغيرات السكانية التي جعلتها أنموذجاً مصغراً للعالم الإسلامي المترامي الأطراف والمتنوع بألسنته وملامحه وخلفياته الثقافية والاجتماعية ومناشطه الاقتصادية. يتضح ذلك في علماء المدينة كما يتضح في تركيبتها السكانية والاجتماعية، كما يتضح فى بيئتها العمرانية.
يقدر عدد سكان المدينة عند ظهورالإسلام فيها بحوالي عشرين ألف نسمة تضاعف إلى حوالي ستين ألف عند وفاة رسول الله صلى الله عليك وسلم سنة 11هـ/632م. وكانت التركيبة السكانية في ذلك الوقت تتألف من القبائل العربية في المقام الأول وفي طليعتها الأوس والخزرج إضافة إلى عدد محدود من اليهود. ثم تفاوتت الأعداد وتغير التنوع مع تغير العصور فتناقصوا في العهدين العباسي والمملوكي إلى أقل من نصف سكان مكة المكرمة ثم ارتفع العدد خلال العهد العثماني نتيجة لعناية سلاطين آل عثمان بالأراضي المقدسة إلى ما بين 16و20 ألف نسمة، وكان لبناء الخط الحديدي الحجازي في مطلع القرن العشرين أثرعلى نمو أكبر وصل بعدد السكان إلى حوالي ثلاثين ألف نسمة. ثم عاد السكان إلى التناقص بعد الحرب العالمية الأولى ليرتفع مرة أخرى في العهد السعودي بزيادة سنوية ما بين عامي 1382 و1391هـ، 1962 و1971 مقدرها حوالي 10%، وفي إحصائية عام 1419هـ/1998م بلغ عدد سكان المدينة 817 ألفاً 137 نسمة.
هذه البيئة السكانية جاءت متنوعة بطبيعة الحال في خلفياتها الاجتماعية والثقافية، الأمر الذي انعكس على الخصائص العمرانية للمدينة على الرغم من خصائصها الثابتة والمتمثلة فى وجود الأماكن المقدسة وتأثيرها على المتغيرات الأخرى. لقد تحول مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى مركز طبيعي للنمو العمراني والسكاني للمدينة منذ تأسيسه، حيث تنامت حوله المساكن والأسواق ودور العلم كالمكتبات. وكان للتوسعات المتكررة للمسجد النبوي أثرها على توسع المدينة نفسها فتجاوزت أسوارها التي أحاطت بها في العهد العثماني حتى بلغت مساحتها المعمورة 293 كلم مربع مقارنة بأقل من 2 كم مربع داخل السور.
كانت أحياء المدينة قبل الإسلام تنمو منفصلة حول مصادر المياه، لكن مجيء الإسلام شجع على تقارب الأحياء لتتشكل من ذلك أول مدينة إسلامية في التاريخ، وحين جاء التوسع والتحديث العمراني كان لابد لذلك التقارب أن يضعف. غير أن مركزية الجامع النبوي ظلت قائمة حتى اليوم، وقد ظلت معها بعد الطرز المعمارية الحجازية والعثمانية التقليدية في واجهات المباني وتصميم المنازل وتقاربها على الرغم من ضغط التوسع والتحديث اللذين أديا إلى إزالة الكثير وحلول طرز معمارية معاصرة تجعل المدينة أشبه بالمدن السعودية والعربية بشكل عام.
لقد انفردت المدينة عن بقية مدن المملكة، ومنها مدن الساحل الغربي، في سيادة ما يعرف بنظام الأحواش في تخطيط المساكن، ويختلف ذلك النظام عن النظام الرئيس الآخر السائد في مدن أخرى وهو نظام الحارة بأنه في حين يتمثل النظام الأخير بوجود شارع رئيس اسمه الحارة تتفرع منه شوارع جانبية تصطف عليها البيوت، يتسم نظام الأحواش بوجود شارع رئيس أيضاً لكنه يفضى إلى بوابات على جانبيه وتؤدي البوابات على فضاء يسمى «حوش» تصطف البيوت حوله. وقد ساعد هذا النظام على مزيد من التقارب الاجتماعي حيث يلتقي الناس في الدخول والخروج وفي مناسبات مختلفة. ومع أن كثيراً من الأحواش قد أزيلت أو تهدمت أجزائها فإنها ما تزال باقية في الذاكرة بأسمائها مثل حوش خميس وحوش القشاش وحوش المغاربة وحوش الخازندار، وحوش الأشراف، الخ. وتتفاوت هذه الأحواش في المساحة حسب قربها أو بعدها عن الحرم المدني، فهي تصغر كلما اقتربت من الحرم والعكس صحيح.
وكما تشير بعض أسماء تلك الأحواش، فإن سكان المدينة المنورة تنوعوا كثيراً سواء في أصولهم العرقية ومستوياتهم الاجتماعية وتخصصاتهم الاقتصادية والمهنية. وإذا كان هذا هو الطبيعي في المدن الكبرى فإنه يصدق بشكل خاص على مدينة يؤمها المسلمون من كل صوب فيعود بعضهم ويبقى البعض الآخر، وقد انعكس هذا على التركيبة السكانية وعلى النسيج الاجتماعي والعادات وكذلك على المردود الثقافي والعلمي، فكان التنوع مصدر إثراء للمدينة وما حولها وعلى عطائها على النحو الذي يتضح مما سيأتي ذكره من معلومات.